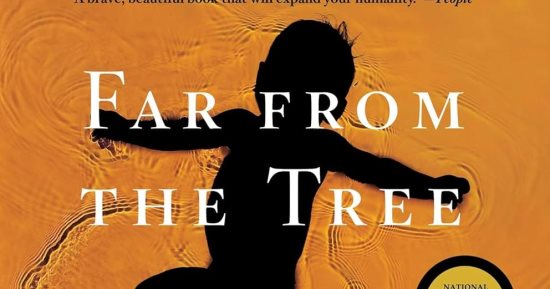"فتيان دمشقيون في نزهة" لنوري الجرّاح: شاعر المدينة وغزاة الداخل
تعني العودة إلى الشاعر السوري نوري الجَّراح (1956)، الرجوع إلى أجواء الدراما الشعرية والأسطورية في مسرح التاريخ وحكاياتهِ، فالقارئ لمُجمَلِ أعماله الشعريّة يجد بينها تواصلاً على اختلافِ أزمنةِ صدورها، كما هو الحال مع ديوان "فتيانٌ دمشقيونَ في نزهةٍ"، الصادر حديثًا عن "منشورات المتوسط".
يتوزَّع الكتاب على خمسةِ فصولٍ، هي: "الألواحُ السبعة"، و"فاكهةُ صَيفٍ في صِحافٍ"، و"قِناعٌ يَتَمَرأى في قناعٍ"، و"البرابرة والغُزاةُ والمدينةُ"، و"قصيدة الأرض"؛ ترافقها تخطيطاتٌ تجريديّة للفنان والنحات السوري عاصم باشا.
يُواصل الجَّراح بهذا الديوانِ مشروعه الشعريّ الذي يُمثّل بِكلِّ ما أنتجه قصيدةً طويلةً جِدًا، تبدأ من أوّلِ لحظةٍ للكتابة، ولن تنتهي بهذا الديوان. هكذا نحنُ أمامَ ترابط شعريٍّ ملحميٍّ مُمتدّ على طول المسيرة الشعريّة التي، وإن اختلف فيها الأسلوب وتحديثات بنيةِ القصيدة بفعل التجربة والزمن، إلا أنها في كلّ الأحوال تبقى في عالمه الذي نعرفه على البعد والقرب ولا يشبه غيره.
إنّ القصيدة التي تصلح للقراءة مرّة واحدة تُستهلك بسهولةٍ ولا تنفع معها القراءات المتعددة. وهذا بالطبع يعودُ إلى طبيعة القصيدة نفسها، من حيث لغتها وبنائها ومهارة الشاعر في كتابتها، منزاحًا ومؤلِّفًا للخيالات ومُشكِّلًا للصور ومبتكرًا فيها، إضافةً إلى ما يُدرجه في نصّه من سينمائية ورؤية من زاويا متعدّدة الأبعاد. الأمر الذي من شأنه أن يُجدِّد القصيدة عند كلِّ قراءةٍ ولا يستهلكُ قدرتها على الاستمراريّة الشعريّة. هذا تحديداً ما تفعله قصيدة الجراح، بل ما يفعله ديوانه موضع الحديث، إذ نجد أنَّنا أمام المتانة التي نعرفها عن صاحب "حدائق هاملت": قوّة جملته، إبهار صورته، ولذة تأويل تركيبته الشعريّة والإنصات لصوتها.
ترابط شعري ملحمي يمتد على طول تجربة الشاعر
إلى جانب ذلك، إن في ديوانه هذا شيءٌ من الغرائبية والكابوسيّة التي يراها الشاعر من زاوية الانحطاط الإنساني وما من شأنه أن يعتمل في نَفْس الرائي والأعمى، بل قل إنها تداعياتٌ عبثت بالنفس حتى صارت ترى ما تستغربه وما تخافه وتنفر منه.
الجرّاح مسكونٌ بالمكان، المكان الذي لم يخرج منه شعريًّا وإن خرج جسديًّا وعاش متنقِّلًا بين بلدانٍ عدّة. هذا الديوان هو من شاعرٍ عاشقٍ للمكان الذي يشهدُ دماره ومأساته وليس بيده سوى أن يكتبه. فهو يكتبه راثيًا أو مُحبًّا شاهدًا أو شهيدًا فيه. دمشق التي كنتُ أجدها بين قصائد الشاعر وأتلمّسُ تفاصيلها وأدخل إلى روحها، تحضر الآن في ديوانهِ بصورةٍ كاملة، دمشق المكان الشاعريٍّ الذي تنطلقُ منه محامل القصيدة التراجيدية ومأساتها التاريخيّة. إنَّها العلاقة التي لا تزداد إلا متانةً مع ازدياد البُعد، حيث نزهةُ الفتيان هنا هي نزهةٌ في الوجود الأول للإنسان السوريِّ، أيَّ سوريٍّ شهد المكان وذاب فيه ثمَّ رآهُ في حالٍ تجرح العين، بل تفقأها:
"من أي الطرقِ أصلُ إليكِ، يا دمشق، يا مدينتي المسحورة،
أيَّ بابٍ أطرقُ لِيُفْتَح لي، أنا الهاربُ وورائي سياطُ الصَّحراء،
أسيرُ في أَرْضِ ضَرَبَتْهَا الزلازلُ
أخوضُ فِي عَمَاءِ تَحْتَ سَمَاءِ تَتَشَقَّقُ.
المرايا تَنْفَطِرُ وتَبْتَلِعُ الجبال.
تَائِهٌ تَحْتَ سَمَاءِ هاذية، كُلَّما بلغت أرضاً، رجمها الغيبُ، وتشقّقت تحت قدميّ.
حتى لكأنني هارب من آلهة لاهية لا تَرْمي لي قارباً إِلَّا لِتُرْسِلَ في إثره
كرةً من اللهب.
أَعْمِضُ وأغيب في رمال لاهبة...
خَفْقُ عَمَاء
خَفْقُ عَمَاءُ".
إذا لم يكتب الشاعر مكانه وزمانه بما يشهده حقيقةً فما عساه أن يكتب؟ وإذا لم يكن الشاعرُ صوت الإنسان ومؤرّخ تاريخ انهزامه أو انتصاره، فماذا عساه أن يفعل؟ لا يخترعُ الشاعر مأساته حسب مزاجه، أو رغبة في أن يعيش فيها، بل يكتب حقيقته ويسطّر لحظته التي يشهدُ فيها دمار مكانه ودمار عالمه أمام لحظاتٍ سعيدةٍ لا تمثّل شيئًا أمام الخُسران. وهذا ما يرفع عن الشاعر، أيّ شاعرٍ، تهمة المأساويّة وتوظيف شعره من أجلها. إنّ الشاعر محكومٌ بلحظته، لحظة الكتابة عمّا يشغله ويراه، وهذه اللحظة هي التي تحدّد المسار وتضع اشتراطاتها، وليس الشاعر العربيّ بهذا المعنى سوى لحظته. إنها لحظة مشتعلةٌ بنار المكان وخاضعة لنكبة الزمن الذي يُساق إلى القصيدة كي يصوّر فيها خيبته:
"أخطو وأَخَالُ أَنَّنا لَمْ نَكُنْ هُنَا يَوْمًا
وَهَذِهِ الكُسُورُ في الأضلاع،
والشَّمْسُ التي اسْوَدَّتْ في دَمِنَا،
وَيَبِسَتْ على أَرْضِ المَقْتَلَةِ،
لم تكن سوى سطرٍ في حكايةٍ رُويتْ على فِتْيَةِ اضْطَجَعُوا في ظلال شجرة على الطريق.
سَطَرٌ هَارِبٌ مِنْ صَيْفِ مُفْعَمٍ بِهَوَاء سَمَرٍ فِي صَيْف.
مَشَيْنَا النَّهارات، وخطونا الليالي،
طالبينَ دِمَشْقَ التي تَركنا في الأصياف".
يكتب الجراح في أغلب قصائده ذاتَه، وذاته ليست ذاتًا شخصيّة محدودة بقدر ما هي ذات الإنسانيّة التي تشتركُ في أنَّها تتعرض لاضطهادٍ وتقاومه، ذاتٌ فاقدةٌ ومفقودةٌ أيضًا. والحديث عبر الذات شعريًّا يمثّل التفافًا إلى القارئ، لا يلبثُ فيه أن يذهب صوبَ جهةٍ حتى يجد أنَّه يعود إلى نفسه، ليجدَ حاله في خضمِّ القصيدة التي يتمرأى فيها عاريًا وكاشفًا عن تفاعله الإنسانيّ مع محيطه. لهذا فإنّ ذات الجماعة هي ذات تجمع الشاعر وأقرانه تحت خيمةٍ واحدة، يصير فيها القارئ والشاعرُ واحداً:
"هَلْ كُنْتُ طوال الوقت أتَلصَّصُ على حياتي
أمْ كُنتُ أخرجُ إلى خَلاءٍ لأصطادَ الحكاياتِ،
ولأروي لشُبَّاَن يافعينَ ما كنتُ أخافُ أن أروي لنفسي في عَتْمَةِ
البيت؟
ومن ثمَّ، بعدَ عطشِ الهاجِرَةِ وشربةِ الماءِ،
بَعْدَ خُطُوَةٍ فِي الرَّمْلِ وَأُخرى في المدينةِ المتلألئة عن بعد،
أعثر على المرأةِ
وأتوارى في غيابةِ البئر
في انتظار أن أروي لِمَنْ سَوْفَ يَرْمِيه في جواري سيّارةٌ ماكرون.
كل ما في جعبتي، أنا المسافر في لهبِ الصّحراء
حكاياتٌ عن وقائع ما كَانَ لها أَنْ تَحدُث
لولا أن في جواري، الآن، فتىً خرج به إخْوَتُهُ في نزهةٍ
ورموهُ
في
جواري".
في قصائد الكتاب انسيابيّة شعريّة في توظيف الكلمة التي تؤدي دورها برشاقةٍ تامّة، مزية تجعل قصيدة الشاعر مرنة صوتيًّا وبلا تنافر لفظيّ، حتى كأنّنا نتخيّله يكتب القصيدة بطريقةٍ غنائيَّةٍ دراميّةٍ تُرى فيها وتسمعُ وتنشد:
"اليومَ نذهبُ إلى الحقلِ،
ولن نَجِدَ أَرْض المعركة،
لا نِبالَ، ولا أقواسَ،
لا حِرابَ
ولا طَعناتْ.
تركنا السيوف في الخزائنِ،
والدُّرُوعَ التي كَتَبَتِ القَصَصَ تَرَكْنَاها في الظِّلالْ..
التُّرابُ غَيَّبَ الحِراب المَكسُورةَ في الأعناقِ،
والجريحُ الذي تقلّب قُربَ مَصْرَعِهِ، مَرَّ على جبهتِهِ، خَفيفاً، هَواءُ الأصيل
ولم يَكن في صدرهِ أثرٌ من طعنةٍ".
إنّ غزاة المدينة التي يكتب عنها الجرّاح، هم غزاة الداخل، لا الغزاة القادمون من خارجها. فهم يولدون فيها ويخرّبونها ويُشرِّدون أهلها، كيف لا والطغاة غزاةٌ أيضاً، السلطويون والمنتفعون من السلطة بأقنعتهم المختلفة ومن يؤدّون دور الجلّاد بإخلاص. يكتب في قصيدة "الغزاة يولدون في المدينة":
"الغزاة الذين انتظرتهم خارج قصيدتكَ
كانُوا وراءَكَ في المَدِينَةِ:
الطَّحَّانُ اللَّص،
وسَارِقُ العَجَلة من المعبد،
التاجر اللاعب بالنُّقُودِ، والقَاضِي المُرتَشِي،
المُحَامِي المُصَابُ بالكَلب،
والعَسْكَري صاحب النياشين، والجندي الراغب في سَرِير المُتْعَة.
وفي حَضِيْضِ السُّلَّمِ كَاتِبُ التَّقْرِيرِ بِمِدَادِ العِلْمِ".
دمشق مدينة عذاب أُسطوريّ تنطلق منها قصيدته
كتب الشاعر قصيدته هذه عام 1991، وهو يُعارضُ فيها قصيدة "في انتظار البرابرة"، لـ قسطنطين كافافيس، لكنَّه بعد أربعة عقود يكتب قصيدة "وصول البرابرة"؛ وهي القصيدة التي نسفت تلك المعارضة، وأرتنا وصول البرابرة الى المدينة، لكنَّهم وعلى حدِّ قول الشاعر، لا يجدونَ منها شيئًا، فهي ليست سوى مدينة للعذاب الأسطوريّ، يكتب:
"عِنْدَمَا وَصَلَ البرابرة إلى أسوار المَدِينَةِ كانت الأبواب مُشْرَعَةً
والسُّكُونُ يَغمُرُ المَطالِعَ وَالشَّرُفَاتِ، وَيَهِيمُ فِي الْأَزقَةِ
كانَ النَّهارُ في أَوَّلِ شَبَابِهِ والشَّمْسُ بِلِسَانِهَا الدَّافِئ تَلْحَسُ الجُدْرَانَ..
الخَواءُ رَجَعَ أَصْدَاء سَنَابِكِ الخَيْلِ...
لمْ يَكُن في الساحةِ المسكونةِ بالهجرانِ حِصَانٌ ولا عربةٌ
لم يكن وراء الأسوارِ قائدٌ، ولا فَتَاةٌ شُجَاعَةٌ تُلْهِمُ المُدَافِعِينَ،
لَمْ يَكُنْ حَارِسٌ هُنَاكَ وَلا حَتَّى نَافِخُ بُوق".
إذا كان ديوان الجراح يحمل عنوان "النزهةِ" التي لن تكونَ كذلك، فإنّ القارئ لا محال سيخوض نزهته الشعريّة التي تبدأ مع القصيدة الأولى ولن تنتهي مع نهاية قصائد الكتاب.
* شاعر من العراق
مشاركة الخبر: "فتيان دمشقيون في نزهة" لنوري الجرّاح: شاعر المدينة وغزاة الداخل على وسائل التواصل من نيوز فور مي

 تريند مصر الآن expand_more
تريند مصر الآن expand_more تريند السعودية الآن expand_more
تريند السعودية الآن expand_more