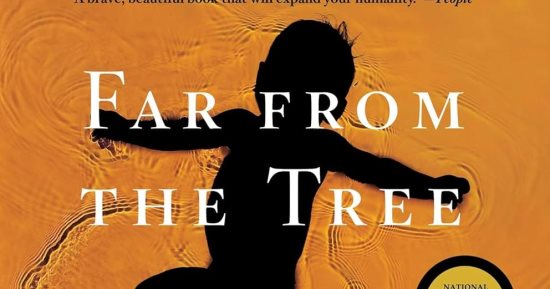هندسة الأبارتهايد.. لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟
لم يكن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع مساكن أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومنحها لمستوطنين يهود سوى حلقة جديدة في مسلسل ابتلاع الأراضي الفلسطينية الذي تمارسه سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود. لكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد الاستحواذ المجرد على الأراضي إلى كونه خطوة ضمن خطة إسرائيلية شاملة لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وفرض العُزلة عليهم من خلال المستوطنات، التي تُعَدُّ في جوهرها وسيلة لتفتيت المدن الفلسطينية وعزلها، ووأد أي بذور للمقاومة وضمان السيطرة الكاملة للمحتلين.
في صبيحة الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 2005، استيقظ الفلسطينيون في قطاع غزة على خبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد وجود دام 38 عاما[1]، مُخلِّفة وراءها أكثر من 6000 دونم من أراضي القطاع التي اغتصبها الاحتلال، التي أقام فوقها 21 مستوطنة يهودية، سلبت الفلسطينيين أرضهم وشاطرتهم العمران لأربعة عقود. ذلك العمران الذي حمل معنى أكبر من كونه حجارة صمّاء، فكان عين الاحتلال العسكري. فإلى جانب السلاح، ثمّة جسد لمستوطن وبيت يحمله يحتلان الأرض، ويمارسان الرقابة التي تُيسِّر للسلاح القيام بوظيفته.
انتهى الانسحاب، وعلى ركام 3000 مبنى استيطاني هدمتهم قواته، رفع الفلسطينيون آلاف الرايات واللافتات التي تحمل صور الشهداء والقادة، مُطالبين بحرق ما تبقَّى من هذا العمران الصهيوني المتروك، إذ كيف يسكن الفلسطيني في منزل أنشأته قوة اضطهدته وأذاقته صنوف العذاب؟ وعلى الجانب الآخر، كان “بنيامين نتنياهو” يشاطر الفلسطينيين رؤيتهم، ولكن لدواعٍ مختلفة، حيث رأى حتمية تدمير ما بقي من المستوطنات؛ “لتجنُّب الصور الهدّامة أيديولوجيًّا، التي يرقص فيها الفلسطينيون على أسطح هذه المباني، ويُحوِّلون كُنسها إلى مساجد”.[2]
وبين الموقفين -الفلسطيني والإسرائيلي- أطلَّت الحكومة الأميركية برأيها، مُقترحة على حكومة الاحتلال تسليم مباني المستوطنات والأصول الزراعية والصناعية المتبقية للفلسطينيين، من أجل إنعاش الحالة الاقتصادية للقطاع[3]، بما يتواءم مع أجندة أميركا النيوليبرالية لتمدين الشرق الأوسط وتحويله إلى مجتمع ليبرالي حديث، الأمر الذي قبلته الحكومة الإسرائيلية، فعرضت هذه الأصول والمباني للبيع على الفلسطينيين، أو منحهم إياها مقابل المنازل التي أُجبِروا على تركها أثناء النكبة، لكنّ الفلسطينيين اعتبروا قبول ذلك خيانة للقضية وتسليما بخسران حق العودة إلى ديارهم التي بُذِلت في طلبها الدماء.
وعن هذا السجال الدائر، يجادل المعماري والكاتب “إيال وايزمان” في كتابه “أرض جوفاء.. الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي” أن العمارة هي إحدى الوسائل المباشرة للاحتلال، حيث “أصبح للأبنية دور فعّال في انكشاف الدراما السياسية”، فبدا أنها “اكتسبت سمة موضوعية اعتُبِرَت العناصر المعمارية -بناء عليها- متعضيات[أ] تنبض بالحياة، ولتطهيرها من الشر سيجب على المعماريين حرقها”، الأمر الذي سيؤدي، وفقا للأمين العام لوزارة التخطيط الفلسطينية “جهاد الوزير”، إلى انعتاق تطهّري من بقايا الاحتلال[4].
بهذا الفهم المختلف لهندسة الاحتلال، رفض الفلسطينيون حتى فكرة تدمير الفلل الاستيطانية، التي عرضها “خافير سولانا” منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واستبدالها لصالح مبانٍ شاهقة لإسكان اللاجئين بها[5]؛ حتى لا تتحوَّل المساكن المؤقتة إلى مبانٍ دائمة تُقوِّض حق العودة الذي يطالب به ويسعى إليه كل فلسطيني هجر داره في 1948.
على الجانب المُقابل، دائما ما رأى الاحتلال في المخيمات بيئة تحضّ على المقاومة، فضلا عن بنيتها التي تعوق الكشف عمّا يجري بها، مما دفع “آرئيل شارون”، في فترة قيادته للجبهة الجنوبية أوائل السبعينيات، إلى تدمير مخيّمات الشاطئ وجباليا ورفح للاجئين بغرض تشريدهم، وما سيترتَّب عليه من احتياجهم إلى منازل جديدة، الأمر الذي سيُجبر الحكومة على وضع برامج لتوطينهم، مما يعني تفكيك بنية المخيّم لصالح هندسة احتلالية تساهم في وضعه تحت العين بلا أزقة ومخابئ يصعب كشفها، ويُعَدُّ هذا هو الدور الأكثر محورية الذي تلعبه المستوطنات، التي تضع يدا وعينا للاحتلال في قلب العمران.
هذه الأيديولوجيا الهندسية للهيمنة، من جانب الاحتلال، دفعت “إيال وايزمان” إلى محاولة تحليل تجليّاتها في الواقع الفلسطيني، بين العزل الحجري للقدس عن الفلسطينيين، والاستيطان، والجدار العنصري، ومنافذ العبور، وحروب الجدران، وغيرهم من آليات الهندسة، في محاولة لفهم الغرض السياسي والعسكري منها على أرض الواقع، لأن المعماري الصهيوني، حسب “وايزمان”، عسكري وناشط سياسي، وليس مجرد كفاءة محايدة تُقدِّم خدمات مدنية. هذه هي الحقيقة الأداتية لهندسة الاحتلال كما يقول الرجل، لكن السؤال: كيف تعمل هذه الأداة؟
في السابع والعشرين من يونيو/حزيران 1967، وبعد أيام قليلة من إتمام الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشرقي من القدس، سارعت حكومة الاحتلال برئاسة “ليفي أشكول” إلى احتلال قرابة 70 كم مربع من الأرض وضمّها ضمن الحدود الإدارية للقدس الغربية المحتلة[6]، وصمَّمت اللجنة العسكرية حينها المخططات المعمارية في خطوة استباقية، تحسُّبا لأي عملية انسحاب يفرضها قرار دولي، بغرض ضم أكبر قدر من المناطق الخالية إلى حدود السلطة الإسرائيلية المزعومة على القدس[2].
وبالفعل، أُرسيت في السنة التالية خطة شاملة، قائمة على لمِّ شمل القدس وضمان وحدتها تحت السيادة الإسرائيلية وبنائها على نحو يردع أي احتمالية لإعادة تقسيمها[7]، مما أدَّى -بالتضامن مع خطط إنشائية أخرى- إلى بناء اثني عشر حيا يهوديا، على مدار أربعين عاما، تحافظ فيها هذه الأحياء على كونها مبتعدة ومتجانسة في الوقت نفسه، بحيث تُشكِّل حزاما من النسيج المعماري المُطوِّق للأحياء والقرى الفلسطينية وتقسمها إلى شطرين، إضافة إلى المدن الصناعية التي بُنيت خارج هذه الأحياء للمحافظة على عزل العمالة الفلسطينية، القادمة من الضفة الغربية، بعيدا عن القدس.
أضف إلى ذلك حلقة المستوطنات الثانية، المُسماة بالجدار الثاني، التي بُنيت خارج الحدود المحلية للقدس؛ ليتعاظم المد الاستيطاني بها وتصير القدس الكبرى مدينة مترامية الأطراف، تعزل الفلسطينيين عن مراكزهم الثقافية فيها، وفي الوقت نفسه تفصل بين شمال الضفة وجنوبها، مُشكِّلة بؤرة استيطانية تحوي ثلاثة أرباع المستوطنين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967[2].
ولم تتوقف المشكلة التي واجهها المعماريون عند الإسراع في البناء وتوفير البنية التحتية للمستوطنات وما إلى ذلك، ولكن بدت المشكلة الثقافية قائمة هي الأخرى، إذ كيف يمكن تأهيل المناطق المحتلة، لتحظى في نفوس المستوطنين بمكانة مألوفة، فتبدو كأجزاء عضوية من العاصمة الإسرائيلية الموعودة في القدس؟ هنا جاء دور الهندسة المعمارية التي وفَّرت “لغة بصرية اتُّخذت وسيلة للتعمية على حقائق الاحتلال ولدعم مطالب التوسع المناطقي”[2].
أدَّى هذا الوضع إلى “ظهور نمط معماري إسرائيلي يتنافر تماما مع طريقة البناء في القرى العربية، ففي المناطق الإسرائيلية، يجهد المهندسون المعماريون ومخططو المدن في تطوير أسلوب معماري قومي”[8]، فكُرِّسَ فصل خاص من خطة 1968 لمناقشة مرسوم الحاكم العسكري لمدينة القدس في فترة الانتداب البريطاني “رونالد ستورز”، والقاضي باستخدام أنواع مختلفة من الحجر الجيري، عُرِف فيما بعد بحجر القدس، مادةً لبناء الجدران الخارجية لمنازل اليهود، بما يُوحِّد السمة المعمارية للمباني المختلفة ويظهرها كأجزاء عضوية من بنيان المدينة.
وقد نصَّت الخطة المذكورة على أن البصمة البصرية التي يُضفيها الحجر “لديها قيمة تنطوي على ما تحمله من رسائل وجدانية، تستنهض المشاعر الأخرى القابعة في ذاكرتنا الجمعية، وتخلق -في سياق البنيان الجديد- وشائج قوية مع مدينة القدس المقدسة التليدة”[7]. ومن هذا المنطلق، استُخدمت التبريرات الدينية اليهودية، والادعاءات الأركيولوجية “المعمارية”، ذرائع لاكتساب الأراضي -بدعوى احتوائها على آثار مقدسة- فضلا عما يحويه الحجر الجيري نفسه -كما تصور “ستورز”[9]- من إرث توراتي لمدينة القدس، التي تعني المدينة المبنية على الحجر.
وقد كانت الغاية من هذا القانون، الذي أُعيد اعتماده، مع تعديلات تسمح بالتحجير المظهري للبناء بدلا من بنائه كاملا بالحجر، تعزيز الرمزية الاستشراقية للمكان، الأمر الذي يُلخِّص، وفقا لـ “وايزمان”[8]، الهيمنة الإسرائيلية على ثقافة البناء في الأراضي المحتلة؛ وهو ما يوقع الخطر على الهوية الوطنية الفلسطينية بالقدس في المدى البعيد، عن طريق هذا الأبارتهايد[ب] الهندسي الذي يعزل الفلسطينيين بعنصرية ويمنعهم حقوقهم في مدينتهم التاريخية.
إيال وايزمان يشير إلى الجدار الجيري المحيط بالبناء الأسمنتي والمستخدم في تحجير المظهر الخارجي للقدس (مواقع التواصل)
وقد تجلّى هذا الفصل الهندسي في الإستراتيجية الديموغرافية للاحتلال في القدس؛ فتقول مهندسة المدن، “إلينوار بارزاكي”، عن السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية حين تنوي التعامل مع مشكلة الكثافة السكانية: “هناك قرار حكومي بالإبقاء على النسبة بين السكان العرب والسكان اليهود في المدينة بمعدل 28% من العرب و72% من اليهود. والأسلوب الوحيد لمعالجة الموضوع، بحيث تتحقَّق النِّسَب المذكورة، هو من خلال إمكانات الإسكان”[10].
نُفِّذت هذه السياسة، كما يقول “وايزمان”، من خلال التلاعب بالخطط العمرانية، باستخدام واحدة من سياستَيْن، أو كليهما: تشجيع بناء البيوت في الأحياء اليهودية، والحدّ من توسُّع البيوت الفلسطينية، وذلك لمواجهة النمو الديموغرافي السريع لدى الفلسطينيين. تظهر نتائج هذه السياسات عند مقارنة حجم تصاريح البناء الصادرة لكلٍّ من الفريقين، فبلغ نصيب اليهود 1500 تصريح سنوي، ساهمت في إرساء 90.000 وحدة سكنية لليهود بالجانب الشرقي من القدس المحتلة، في مقابل 100 تصريح سنوي فقط للفلسطينيين أصحاب الأرض[11].
علاوة على ذلك، اعتُبر إنشاء أحياء/مستوطنات يهودية جديدة -في جوهره- “إجراء مضادا لحركة العمران الفلسطينية، وجرى تخطيط تلك الأحياء والمستوطنات بحيث تُشكِّل أسافين بين الأحياء والقرى الفلسطينية، تحد من إمكان توسُّعها، وتُجزِّئ التواصل العمراني الفلسطيني”، كما هو الحال في حي رامات إشكول وحي التلة الفرنسية اللذين يُشكِّلان “قوسا ممتدا يفصل حي شعفاط الفلسطيني عن البلدة القديمة الفلسطينية وعن حي الشيخ جراح، وهذه المناطق كلها كانت تُشكِّل منطقة عمرانية متصلة”، لتبرز الوظيفة الأساسية للمستوطنات فيما بعد، في القدس وغيرها، بوصفها وسيلة لمنع المدينة “من أداء وظيفتها، ولجعل الحياة فيها أصعب على الفلسطينيين”[8]، فضلا عن تسهيل المراقبة الأمنية والتوسُّع الجغرافي وكسب أكبر قدر ممكن من الأراضي مهما تعارض ذلك مع القرارات الدولية.
في عام 1999، تقدَّم بعض المستوطنين بشكوى إلى الجيش الصهيوني يشتكون فيها من الاستقبال السيئ في هواتفهم المحمولة خلال مرورهم على الطريق السريع الذي يربط بين القدس والمستوطنات في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي استجابت لندائه شركة “أورانج” (Orange) لخدمات الهواتف المحمولة بأن أنشأت هوائيا لاستقبال الإشارة في المنطقة المُشار إليها، أعلى التلة المشرفة على الطريق، وهي القمة ذاتها التي كانت مشروع استيطان لم يُكتَب له النجاح.
كانت تلك التلة المزروعة بالتين والزيتون ملكا لمزارعين فلسطينيين من قريتَيْ عين يبرود وبرقة، لكن بدا لقوات الطوارئ الاحتلالية حينها أن إقامة الهوائي في بؤرة ميغرون، كما ستُسمى فيما بعد، مسألة أمن قومي، ومن ثم يمكنها الاستيلاء على الأرض الخاصة بالمزارعين دون موافقة مُلَّاكها، وهو ما حدث بالفعل، متبوعا بقيام شركة الكهرباء الإسرائيلية بتغذية التلة بالكهرباء، وربط شركة المياه الوطنية لها بنظام التروية المائي، بذريعة دعم عمليات البناء.
دفع التأخير في بناء الهوائي المستوطنين إلى تنصيب هوائي مزيف في مايو/أيار 2001، ثم أتوا بحارس له، للإقامة في عربة مقطورة أسفل السارية، فأتى الحارس بزوجته وأبنائه للإقامة معه، ولم تمضِ عشرة أشهر حتى رافقت خمس أُسر أخرى أسرة الحارس المزعوم، مما أعطى مبررا لوزارة الإسكان والتعمير للمشاركة في الكعكة، فبنت حضانة أطفال للأُسر المقيمة، وجُمِعت التبرعات لبناء كنيس يهودي، لتتحوَّل سارية الهوائي إلى أكبر بؤرة، من أصل 103 بؤرة استيطانية مترامية على امتداد الضفة الغربية، وتضم ما يقارب 60 مقطورة، و42 عائلة[12]، وتحصل على تصريح رسمي بالتحوُّل إلى مستوطنة كاملة البنيان[13].
هل لاحظت شيئا؟ تلك هي الجغرافيا اللدنة -بتعبير “وايزمان”- التي تتمدَّد بها سلطات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، وغزة سابقا، متجاوزة بذلك حدود 1948 و1967 وقرارات مجلس الأمن حول الاستيطان، وكل شيء من شأنه أن يعوق تمدُّدها على أرض فلسطين. فالبؤر المُكوَّنة من عربات متحركة ومخيمات سرعان ما تتحوَّل إلى مستوطات تدريجيا، بشكل يحيل الضفة الغربية، التي كانت متماسكة عقب النكبة، إلى أرخبيل -جزر منعزلة- بفعل الاستيطان والجدار العازل، وهو ما يُعَدُّ تحقيقا للسياسة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “شارون” من قبل: “أنا أستوطن حيث أستطيع”[2].
تُشكِّل المستوطنات، من حيث هي أداة معمارية إذن، غرضا عسكريا وسياسيا بالغ الأهمية للاحتلال، ولهذا السبب يتمركز وجودها بشكل طاغٍ في أعالي التلال، وهو الموقع الذي صيغت له ذريعة دينية تزعم أن السهول هي مناطق الدنيا التعيسة وأن المرتفعات هي القمم المقدسة التي لا ينبغي تركها في أيدي الغرباء[14]. تلك الحجة التي خدمت الغرض الأساسي من اعتلاء التلال بالمستوطنات، كما يشرحه “وايزمان”، لتكون عينا كاشفة لما تحتها من الوديان الفلسطينية، لإحكام الرقابة التامة، وهو ما يُبرزه تصميم المنازل الاستيطانية، إذ يُمثِّل كل منزل بؤرة رؤية دائرية، أشبه بـ “تذكرة المرمى” للجنود أثناء الحرب[ج]، فيُشكِّل كل منزل -مع مجموع المستوطنة- عينا كبيرة تكشف الوديان وما يجري بها.
إضافة إلى ذلك، ساهم كلٌّ من الجدار العنصري، الذي تبنيه قوات الاحتلال حول مستوطناتها، إضافة إلى الأسلاك الشائكة والحواجز وشبكة الطرق والكباري والأنفاق التي تُفتَح حصرا لليهود، في تحقيق الفصل الشديد بين الجانبين، وبسط السيطرة العسكرية التامة، ذات الذراع المعماري الضخم، على الوديان الفلسطينية، إذ تستعمل قوى الاحتلال المستوطنات بوصفها طرقا مباشرة في حال الهجوم على القرى والمخيمات، كما ساعد التوحيد المعماري في الهيئة، مع الأسطح القرميدية الحمراء، في التمييز بين المستوطنة والقرية في حال عمد الاحتلال إلى القصف الجوي.
ويُمثِّل الاستيطان -كونه فعلا هندسيا- هدفا آخر للاحتلال، حسب خطة “إيغال آلون”، الذي كان وزيرا إسرائيليا بعد النكسة، التي نصَّت على حتمية فصل الضفة الغربية عن الأردن من جهة الشرق، وتوفير الحد الأقصى من الأرض والحد الأدنى من العرب، لكن على الرغم من عدم طرح هذا التصوُّر على أنه مشروع رسمي للحكومة الإسرائيلية آنذاك، فإن مشروعه هذا ظلَّ أساسا لسياسة الاستيطان في المناطق المحتلة، وورقة عمل رئيسة في مناقشات الحكومة بشأن المناطق وقضايا الاستيطان وغيرها[15].
ونتيجة لذلك، كانت المستوطنات دائما مواقع إستراتيجية أكثر منها مواقع للإقامة، بل إنها قُدِّمت إلى الجمهور الإسرائيلي المصدوم من حرب 1973 على أنها منظومة دفاعية تسهم في حماية الدولة من الاجتياح، وإجراء احترازي للوقاية من الحرب بالأسلحة التقليدية، وقد أدرك “شارون”، الخبير في مداورة الرأي العام واستثمار الخوف الجماهيري، تلك النقطة جيدا حينما قال: “إذا لم نشرع في الاستيطان في يهودا والسامرة -الضفة الغربية- فستطولنا قذائف المدفعية الأردنية”[2].
وأمام هذا الواقع المأزوم أصبح الفلسطينيون يعيشون في جزر منعزلة ومغلقة، حيث تضم الأراضي الواقعة تحت الحكم الفلسطيني ما يقرب من 200 قطعة متناثرة، في حين تسيطر إسرائيل على المناطق المحيطة بها إلى جانب سيطرتها على مخزون المياه الجوفية، وسيطرتها على الجو الذي يُغِلّف تلك المناطق[16]، ومع سن سياسة منافذ التفتيش المرورية -بعد اتفاقية أوسلو- على تخوم الأراضي المحتلة، جنح الاستيطان لتفريغ الأرض الفلسطينية من محتواها لصالح مستوطناته.
يذكر “وايزمان” أن واحدة من أكثر معارك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني احتداما تلك التي تجري تحت سطح الأرض، إذ يقبع أكثر من 80% من مخزون المياه الجوفية الجبلية تحت أراضي الضفة الغربية؛ مما ينحو بالاحتلال للاستيلاء على الأرض لتسهيل الاستيلاء على باطنها، فيذهب ما يقرب من 83% من المياه المتاحة سنويا في تلك المناطق لفائدة المدن الإسرائيلية والمستوطنات، حيث تتمكَّن مضخاتها العملاقة من سحب المياه الجوفية الفلسطينية لصالحها الخاص.
هكذا صار الوضع إذن؛ سيطرة على ظاهر الأرض الخاضعة للاحتلال الصهيوني، وسيطرة احتلالية أيضا على الغلاف الجوي للأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى سياسة المنافذ ونقاط التفتيش التي تُحكِم القبضة على الحركة والانتقال، مع سياسات الاستيطان التي تُضيِّق الخناق على أراضي الضفة وتحيط بها وتعزلها ببناء الجدار العازل، بجانب الاستيلاء على المياه الجوفية. هكذا صاغ العمران الهندسي آليات السيطرة الحادة للاحتلال، لكن هل انتهى الأمر هنا؟
في الأول من إبريل/نيسان 2002، كان مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية على موعد مع اجتياح عسكري لقوات الاحتلال ضمن خطة حكومة “أرييل شارون” لاجتياح الضفة الغربية فيما سُمِّي بعملية “السور الواقي”، التي أُعِدَّت وتُدرِّب عليها -بحسب اعترافات رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي “موشي يعلون” منذ زمن- تحسُّبا لأي عمليات فدائية فلسطينية مستقبلية، حيث هدفت العملية الإسرائيلية للقضاء على المجموعات الفلسطينية المقاومة، لكن وقوع عملية فندق نتانيا الفدائية عجَّل من تنفيذها.
تسبَّب الاجتياح الذي استمر لأسبوعين في استشهاد العشرات من قاطني المخيم فضلا عن المئات، وقد تكبَّدت قوات الاحتلال بدورها خسائر جسيمة، في حين دُمِّر المخيم بشكل شبه كامل[17]. تلك المجزرة التي لاقت تنديدا دوليا واسعا ولفتت نظر العالم لجرائم الاحتلال كانت إحدى ضرورات جيشه في تطوير بدائل أكثر ذكاء للحرب المدينية.
وفقا لـ “وايزمان”، كان اجتياح جنين مستندا إلى تشكيلة من الأطروحات النظرية التي تنتمي إلى المدرسة الفرنسية ما بعد البنيوية في حقول العمارة والهندسة المدينية، ليُقر بعدها جيش الاحتلال مجموعة من التكتيكات الحربية المختلفة لحروب المخيمات، التي استفاد منها لاحقا الجيش الأميركي في غزوه للعراق. وتقوم هذه التكتيكات على إستراتيجية عسكرية غير تقليدية تعرف باسم “الانثيال السربي”.
استُخدِمت الإستراتيجية نفسها في اقتحام مخيم بلاطة بنابلس في العام نفسه. يشرح “أفيف كوخافي”، قائد كتيبة المظلات التي خاضت الاقتحام، خطته قائلا: “كان الفلسطينيون قد هيّأوا مسرح القتال على ضوء توقُّعاتهم في أننا سنتقيَّد بالمنطق الذي حدَّدوه سلفا لسير الأحداث… بمعنى أن ندخل بتشكيلات ميكانيكية قديمة الطراز، بخطوط متراصة وطوابير محتشدة تتكيَّف مع التنظيم الهندسي للشبكة الطرقية… غير أننا سنقوم بعزل المخيم تماما في وضح النهار كي نخلق انطباعا أننا سنقوم بعملية هجوم ممنهجة، وعندئذ نُطبِّق مناورة تنثال فيها الأسراب في وقت واحد من كل اتجاه عبر أبعاد الجيب المختلفة… فتدفع تحرُّكاتنا خلال الأبنية المتمردين للانتقال إلى الشوارع والأزقة حيث يمكننا اصطيادهم”[19].
هكذا كان الهجوم الجديد: سيتحرَّك الجنود داخل المنازل المدنية لا خلال الطرقات، عن طريق اقتحام المنازل والتجمُّع وراء الجدران، ومن ثم حرقها أو تفجيرها بما يسمح لهم بالمرور خلالها، لتتحوَّل الشقق والغرف إلى ميدان مناورة قتالي، يُحكِم من خلاله جنود الاحتلال سيطرتهم على المخيم من الداخل قبل أن يفاجئهم الفدائيون بقنّاصتهم وكمائنهم من الخارج.
ويروي “وايزمان” في مقابلة له مع أحد الجنود، ويُدعى “جيل فيشباين”، إستراتيجية المعركة، فيكتب على لسان الجندي: “لم نغادر الأبنية مطلقا، وتقدَّمنا بين المنازل تماما، وشققنا بضعة عشر طريقا من خارج المخيم إلى مركزه. لقد كنا جميعا داخل منازل الفلسطينيين، لم يكن أيٌّ منا في الشوارع، وبالكاد غامرنا بالخروج. كانت مهاجع نومنا ومقر قيادتنا داخل هذه الأبنية، حتى العربات وُضِعت في منطقة حفرناها داخل المنازل”[2].
يشرح “كوخافي” نفسه، في حوار آخر مع “وايزمان”، توصيفا للهجوم يُبرز التلاقي بين النظرية العسكرية والممارسة لها من خلال التخيُّل والتنفيذ الهندسي قائلا: “هذا الحيز الذي تنظر إليه وهذه الغرفة التي تنظر إليها ليسا سوى تفسيرك الخاص لهما… السؤال هو: كيف يمكنك تفسير الزقاق؟ هل تُفسِّره بوصفه مكانا، كما يفعل كل معماري، مخصصا للمشي، أم تُفسِّره بوصفه مكانا يُحظر المشي فيه؟ هذا فقط يعتمد على التفسير، وقد فسَّرنا الزقاق باعتباره مكانا يُحظر المشي خلاله، والباب باعتباره مكانا يُحظر المرور عبره، والنافذة باعتبارها موقعا يُحظر النظر من خلاله؛ لأن الأسلحة تنتظرنا في الزقاق، واللغم ينتظرنا خلف الأبواب”.
لقد رأى “كوخافي” أن الفلسطينيين سيواجهونهم بكلاسيكية، وهو لا يرغب في التقيُّد بهذا التفسير، بل يريد مفاجأتهم، فيقول: “ذلك هو جوهر الحرب، أنا بحاجة إلى الفوز وبحاجة إلى الخروج من مكان غير متوقَّع… لذلك اخترنا طريقة السير عبر الجدران كما الدودة التي تشق الطريق بفمها: نظهر في مواضع معينة، ثم نختفي، إن التنقل من خلال الجدران هو حل ميكانيكي يربط بين النظرية والممارسة.
بهذه الآلية المفاجِئة، إضافة إلى الآلية الكلاسيكية الأخرى التي تعتمد على الاجتياح والهدم وتفريغ الطرقات من كمائنها والبيوت من مكامنها، أمكن للاحتلال استعمال المعمار مرة أخرى في تحويل كفة الصراع لصالحه في الضفة، الأمر الذي واجهه عكسيا في قطاع غزة، حينما حوَّله إلى أكبر مختبر في العالم لتجارب الاغتيالات المنفذة من الجو، لتتحوَّل المقاومة من ظاهر الأرض إلى باطنها من خلال الأنفاق في مناورة معمارية أخرى للأرض الجوفاء، ولكنها لم تنل الدعم الحكومي أو التيسيرات الحربية والتعامي الدولي الذي يناله الاحتلال في كل جرائمه.
في النهاية، لا تبدو الكفتان على قدر واحد، ولا حتى متقارب، فقد فرض الاحتلال سيطرة واسعة من خلال أساليب عِدّة وتكتيكات متطورة، الأمر الذي يطيل أمد الصراع إلى وقت يعلمه الله. لكن الأهم في هذا الصدد أن سياسات الاحتلال المعمارية باتت تكشف لنا هي الأخرى جانبا من طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي القادم من عصور الكولونيالية، الذي لا يتوانى عن توظيف أي شيء، بما في ذلك العمارة، من أجل تحقيق أهدافه الإمبريالية والتوسُّعية.
سامح عودة
The post هندسة الأبارتهايد.. لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟ first appeared on سما نيوز | الرابطة الإعلامية الجنوبية.مشاركة الخبر: هندسة الأبارتهايد.. لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي

 تريند مصر الآن expand_more
تريند مصر الآن expand_more تريند السعودية الآن expand_more
تريند السعودية الآن expand_more